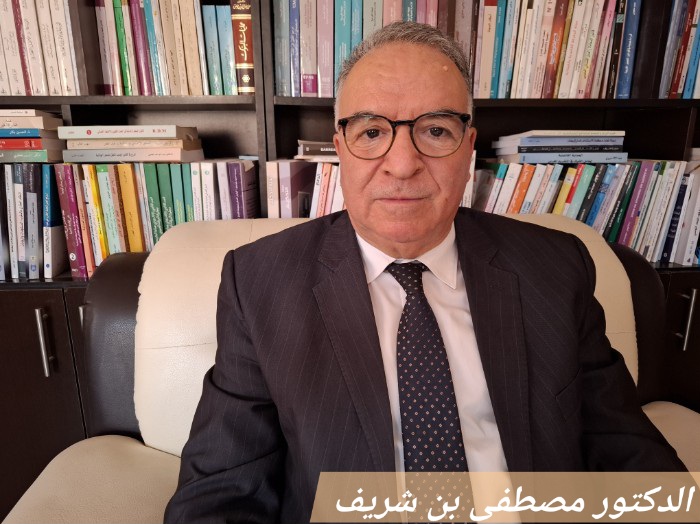صباح الشرق / SABAHACHARK
–الدكتور مصطفى بن شريف/ الجزء الثالث
1- الجهوية المتقدمة بين مدلول النص الدستورى والنص التشريعي
أهم تحول عرفه المغرب بعد الإستقلال، هو الإنتقال من الإدارة المركزية إلى الإدارة اللامركزية، و تم تتويج هذا المسار بتبني الجهوية الإدارية كأسلوب إداري يقوم على توزيع و نقل السلط الإدارية من المركز إلى هيئات منتخبة أو مؤسسات مرفقية، ضمن ما يعرف بتطبيق اللامركزية الإدارية بشقيها الترابي و المرفقي.
وهكذا،وفي إطار حركية الإصلاح الدستوري، تم و لأول مرة تمت دسترة الجهوية بموجب الفصل 94 من دستور 1992، وتم تبني الفلسفة ذاتها في دستور 1996، بمقتضى الفصول 100 و101 و 102، ليتم بذلك الإنتقال من الجهوية الإقتصادية إلى نظام الجهوية الإدارية والإرتقاء بها إلى مؤسسة دستورية، ولم يتم إصدار قانون خاص بها، إلا بعد العمل بدستور 1996 ، وذلك بموجب القانون رقم 47-96 المؤرخ في 02 أبريل 1997
و تقرر على إثره تقسيم المغرب إلى ستة عشر (16) جهة، كل جهة تشمل عددا من العمالات و الأقاليم.
أنه ونظرا لمحدودية نتائج اللامركزية الإقتصادية واللامركزية الإدارية في ظل العمل بتقسيم المغرب إلى سبع (7) جهات إقتصادية، ثم إلى ستة عشر (16) جهة إدارية تبين للدولة بأن الضرورة تقتضي تبني جهوية جديدة” ، و هو ما تم بموجب دستور 2011 الذي نص على الجهوية المتقدمة”، كإختيار لا مركزي للتنظيم الترابي للمملكة، الذي يجمع بين خصائص الجهوية الإدارية والجهوية السياسية، أي أن الجهوية المتقدمة أرقى من اللامركزية الإدارية، و أدنى من اللامركزية السياسية، لأن الدستور لم يكشف بشكل صريحعن مضمون و حدود و أبعاد الجهوية المتقدمة،واكتفى بالتنصيص على أنها شكل من أشكال التنظيم الترابي اللامركزي، لذلك فإن الجهوية المتقدمة بمدلولها الدستوري، قابلة للتأويل بأن تأخذ شكل الجهوية السياسية، لكن المشرع كان له رأي آخر، لما أصدر القانون التنظيمي رقم: 14-111 المتعلق بالجهات، بحيث أنه لم يرتقي بها إلى مرتبة “الجهوية السياسية” بل اعتبرها جهوية إدارية”، بإمتياز، كما هو ثابت من مواد القانون التنظيمي المذكور.
و هكذا جاء في المادة 3 من القانون التنظيمي رقم: 14-111 المتعلق بالجهات، بأن “الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الإعتبارية و الإستقلال المالي و الإداري، وتشكل أحد مستويات التنظيم الإداري للمملكة، بإعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة”.
و يؤخذ من جميع مواد القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات (256) مادة، أنها بوأت “الجهة” مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، العمالات والأقاليم و الجماعات، دون الإفصاح عن البعد السياسي للجهات، مما نكون أمام جهوية إدارية، غير قادرة على إستيعاب مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية” التي أعلن عنها الملك محمد السادس في 06 يونيو 2006، وتم تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في : 07 أبريل 2007 ،والتي تمثل وجهة نظر المغرب الرسمية كحل سياسي لإنهاء النزاع في الصحراء، عن طريق تمتيع الأقاليم الصحراوية بالحكم الذاتي، من خلال إحداث هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة لإدارة أقاليم الصحراء بشكل ديموقراطي، على أن تستمر الدولة المغربية في ممارسة أعمال السيادة بالنسبة لقطاعات الدفاع والسياسة الخارجية، و الصلاحيات الدستورية و الدينية للملك في إطار الدولة الموحدة.
و من المعلوم أن “الجهوية” تهدف إلى دمقرطة صنع أو اتخاذ القرار الذي قد يكون قرارا إداريا أو سياسيا، الأمر الذي يقتضي ليكون ديموقراطيا (أي القرار)، يتعين أن يكونة ذات مرجعية ديموقراطية و التي تمثلها الديموقراطية التمثيلية إلى جانب الديموقراطية التشاركية كبدائل للمركزية الإدارية أو مركزة القرار، و هو ما يطبع أيضا اللامركزية الإدارية التي تمثلها الجهوية في المغرب، و لو في ظل تبني “الجهوية المتقدمة”التي لم يتم الإرتقاء بها إلى جهوية سياسية،رغم أن الدستور نص على أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم
على “الجهوية المتقدمة”.لكن المشرع كان له رأي آخر، بحيث حصرها في مدلولها الإداري بموجب القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، علما أن طرح المغرب لمبادرة لحكم الذاتي في الصحراء كان قبل إصدار القانون التنظيمي للجهات، و كان الأجدر بالمشرع المغربي، أن يأخذ ذلك بعين الإعتبار، عن طريق المزج بين مقاصد “الجهوية المتقدمة “و”أهداف مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء”، بمناسبة إعداد والتصويت و إصدار القانون التنظيمي للجهات، وهو ما يمكن أن نعتبره نوع من “الإغفال”، أو العوار”، التشريعي تم عن عمد أو بإهمال، لما لم يتناول المشرع بالإحاطة الشاملة لموضوع “الجهوية المتقدمة ، و هو ما يعتبر إخلال سياسي وقانوني من طرف المشرع بإختصاصاته الدستورية، و هو موقف سلبي من الموضوع محل التنظيم،
وهو “الجهوية المتقدمة”.
وإذا كان الخطاب الرسمي للدولة يسوق للجهوية المتقدمة كخيار إستراتيجي، لبناء الديموقراطية الجهوية، وكمدخل سياسي لتسوية النزاع في الصحراء، لكن المشرع لم يأخذ بذلك، و لم يتخلص من الإرث التاريخي و السياسي للمركزية الإدارية
و اللامركزية الإدارية، الأمر الذي يتطلب مراجعات تشريعية وسياسية من أجل التجاوب مع متطلبات الديموقراطية الجهوية وآفاق التسوية السياسية المنشودة في الصحراء المغربية.
2- الجهوية المتقدمة مدخل سياسي للحكم الذاتي في ضوء المرجعية الدستورية
بالرجوع إلى تصدير دستور 2011 و فصوله من 1 إلى 180، يتبين بأن المشرع الدستوري، عمل على دسترة الجهوية المتقدمة” في الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من الدستور، معلنا بأنها تشكل أساس التنظيم الترابي للمملكة، بإعتباره تنظيما لا مركزيا دون الإفصاح عن طبيعة “اللامركزية” هل هي لا مركزية إدارية” أم “لا مركزية سياسية”.
و في الباب التاسع من الدستور، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، نص على المبادئ والقواعد المؤطرة لها، في الفصول من 135 إلى 146، ويلاحظ بأنه لم يرد في الفصول المذكورة،ذكر “الجهوية المتقدمة”، بل نصت على “الجهات”، كوحدات ترابية و إحدى صور اللامركزية الإدارية،وهو ما يعني بأن الجهوية المتقدمة” وردت مرة واحدة، في الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من الدستور، علما أن الفصل 146 من الدستور أعلن بأنه تحدد بقانون تنظيمي المبادئ والقواعد التي تحكم وتؤطر التنظيم الترابي للمملكة الذي يقوم على الجهات والعمالات والأقاليم و الجماعات.
إن المشرع الدستوري أكد على مبدأ الريادة للجهات على الجماعات الترابية الأخرى لكنه لما أصدر القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، لم يخرج المشرع عن النظريات التقليدية المؤطرة للامركزية الإدارية، ولم يعكس ضمن أحكامه مفهوم ومدلول الجهوية المتقدمة، علما أن القانون التنظيمي للجهات لا يختلف جوهريا عن القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم و القانون التنظيمي رقم: 14-113 المتعلق بالجماعات، بحيث نكاد نكون أمام نسخة واحدة”، مع فارق في التسميات فقط أملته طبيعة كل جماعة ترابية، وتبعا لذلك تم إفراغ “الجهوية المتقدمة” من مضمونها “المتقدم” أو “التقدمية”، ليحافظ المشرع بذلك على المدلول التقليداني، للجهوية الإدارية” التي تعني التحول من الإدارة المركزية إلى الإدارة اللامركزية، مع تقوية المراكز الإدارية للعمال و الولاة، بوصفهم ممثلين للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمكينهم من سلطات واسعة سواء في إطار الجهوية الإدارية أو بإعمال نظام اللاتمركز الإداري، أي أن الجهوية الإدارية بشقيها، الجهوية الإدارية اللامركزية والجهوية الإدارية اللاممركزة، متحكم فيها و في مفاصلها من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية، و هو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي يرتكز عليها التنظيم الجهوي و الترابي للمملكة، ومن أهمها: مبدأ التدبير الحر، و التسيير الديموقراطي، ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم، هذه المبادئ الدستورية تم الالتفاف عليها بموجب القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية.
و هكذا، يستفاد من القانون التنظيمى للجهات، أنه لم يتخلص من المرجعيات التقليدية المؤطرة للجهوية الإدارية (اللامركزية الترابية واللامركزية المرفقية)، و لم يعكس مضمون “الجهوية المتقدمة”، المنصوص عليه في الدستور، بمعنى أنه ورغم تبني المشرع الدستوري لمفهوم أو نظرية الجهوية المتقدمة”، إلا أن المشرع البرلمان) لم يأخذ بها في القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
و بناء عليه لا يمكن الحديث عن “الجهوية السياسية”، في المغرب، في ظل الأنظمة القانونية الحالية، لأن الجهة في إطار الجهوية السياسية تتمتع بسلطات إدارية و سياسية واسعة، وتتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية بتفويض دستوري، في إطار الدولة الموحدة التي تستوعب أسلوب أو نظام الجهوية السياسية و نظام الجهوية الإدارية، كما هو الحال في إسبانيا مثلا، التي يأخذ نظامها الدستوري “بالجهات”، التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي الموسع في إطار دولة مركزية موحدة، رغم العمل بحكومات و برلمانات جهوية، فإن ذلك لا ينال من وحدة الدولة و سيادتها.
و هكذا، يبدو بأن الجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية وأدنى من مستوى الدولة التي تعتمد النظام الفدرالي الذي يقوم على “الولايات” كوحدات ترابية مكونة للدولة الفدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتكون من خمسين (50) ولاية المكونة للإتحاد الفدرالي، الذي يقوم على النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يركز الحكم أو السلطة في يد رئيس الدولة، الذي يعتبر هو رئيس الدولة الفدرالية، ورئيس حكومتها، ورئيس الولايات المتحدة في آن واحد، الذي ينتخب عن طريق الإنتخابات المباشرة على درجتين و هو القائد الأعلى للجيوش الأمريكية، و له حق إصدار العفو، وتنفيذ القوانين، كما يملك حق الإعتراض على القوانين التي يصوت عليها الكونغريس، أي حق الفيتو (Droit de Veto).
و من جهة أخرى، ليس للكونغريس حق إقالة الرئيس أو إسقاط الحكومة، كما أن الرئيس لا يملك حق حل البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
و من جهة ثانية، أهم ما يميز النظام الفدرالي، أنه يضمن وحدة الدولة في إطار الدولة الفيدرالية، التي تقوم على وحدة “العملة”، ووحدة النظام الجمركي”، وحدة الجيش و وحدة التمثيل الخارجي، ووحدة التراب و السكان والمواطنة.
و من جهة ثالثة، تتمتع الولايات الفدرالية بدستورها و تشريعها وحكومتها، مع العمل في إطار المبادئ الكبرى الواردة في الدستور الأمريكي.
و ترتيبا على ما ذكر، يلاحظ بأن أهم ما يميز الدولة الموحدة عن الدولة الفدرالية أنه في إطار الدولة الموحدة نكون أمام وحدات ترابية و مؤسسات محلية، هي عبارة عن وحدات إدارية تخضع لقانون موحد، يطبق في سائر أقاليم وجهات الدولة.
في حين أن الدولة الفدرالية تتميز بتعدد منظومتها القانونية، وتتمتع الولايات المكونة للإتحاد بممارسة الحكم الذاتي في تسيير شؤونها المحلية، ولذلك فالنظام الفدرالي له بعد سياسي، في حين أن اللامركزية الإدارية نطاقها النشاط الإداري.
و من جهة أخرى، يمكننا القول بأن الجهوية السياسية أو اللامركزية السياسية يمكن أن تطبق في الدول الموحدة أو الدول المركبة ذات النظام الفدرالي، علما أن دولا تحولت من نظام موحد، إلى نظام فدرالي، وأخرى تحولت من دول فدرالية إلى دول موحدة، بمعنى أن اللامركزية السياسية قابلة للتطبيق في الدولة الموحدة كما في الدولة الفدرالية، و عند هذا المستوى من التحليل، لا شيء يحول دون توجه المغرب نحو تبني نظام الجهوية السياسية أو اللامركزية السياسية، كإطار قادر على استيعاب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء أو إعمالها في جهات أخرى، لأسباب تاريخية و إقتصادية و اجتماعية واثنية.
و إذا كانت الدولة الموحدة، تقوم على مبدأ وحدة السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية، و هيمنة اللامركزية الإدارية كأسلوب من أساليب الإدارة، على خلافا اللامركزية السياسية التي تعتبر أسلوبا من أساليب الحكم بنص دستوري، و التي نطاقها الدولة المركبة أو الفيدرالية، حيث تتمتع الجهات أو الفدراليات بجميع سلطات الدولة من تشریع و تنفيذ و قضاء مع إبقاء دولة الإتحاد صاحبة السلطة و السيادة لإدارة مرفق الدفاع والأمن القومي،والتمثيل الدبلوماسي، ورئيس واحد للدولة، واحتكار السياسة المالية والنقدية، ووحدة العملة الوطنية، وهو النظام الذي يتقاطع مع خصائص الحكم الذاتي، القابل للتطبيق أيضا في إطار الدولة الموحدة.
– رابعا في جدلية العلاقة بين “الحكم الذاتي” ،و”الجهوية” :
إن الجهوية، قد تتخذ شكل الجهوية الإدارية اللامركزية الإدارية، أو الجهوية السياسية، فالأولى هي أسلوب من أساليب الإدارة، في حين أن الثانية فهي أسلوب من أساليب الحكم بواسطتها يتم إشراك الجهات في ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الجهة، تحت إشراف الدولة المركزية و في إطار دستورها و وحدة سيادتها.
مبدئيا، نظام اللامركزية الإدارية، لا يتوافق مع نظام الحكم الذاتي”، الأمر الذي يقتضي خلق إطار مؤسساتي قادر على التجاوب مع مقومات “الحكم الذاتي”، كأسلوب سياسي يحكم الجهات وإدارتها ضمن وحدة ترابية وسياسية، يتولى الدستور تنظيم و توزيع الإختصاصات بين الدولة والجهات، و هنا نكون أمام دولة الجهات، أو الدولة الجهوية كإسبانيا، فهي أعلى من الجهوية الإدارية، و أدنى من الدولة الفدرالية (ألمانيا، النمسا، بلجيكا)، وبناء عليه، فإن اعتماد “الجهوية السياسية”، هي القادرة على استيعاب نظام الحكم الذاتي في ظل الدولة الموحدة سياسيا و ترابيا وقانونيا، مع تفويض اختصاصات سياسية و إدارية للجهات في إطار السيادة المغربية، ويعتبر الملك بصفته أميرا للمؤمنين و رئيسا للدولة، هو الضامن لوحدة الشعب والوحدة الترابية، إلى جانب المحكمة الدستورية، التي تتولى وظيفة حماية الدستور و وحدة الدولة ووحدة الشعب، و هي كلها مبادئ ذات قيمة دستورية، تقوم عليها الدولة الموحدة دون حاجة إلى الأخذ بأسلوب الدولة المركبة أو الفدرالية، التي تتكون من شعب واحد لا شعوب رغم اختلاف الاثنيات،
والمقاطعات.
بالرجوع إلى القانون الدولي، لا يوجد به ما يفيد تعريف مفهوم “الحكم الذاتي”، أو مبدأ “تقرير المصير”، لأن تمتيع جهة بالحكم الذاتي، لا يعني بالضرورة الحق في تقرير المصير، لأن الحكم الذاتي قابل للتطبيق دون ربطه بالحق في تقرير المصير، لأن هذا الأخير يندمج في السيادة التي تمارسها سلطات الدولة الموحدة.
و من المعلوم أن “الحكم الذاتي”،أو “الإستقلال الذاتي”،طبقته بريطانيا لأول مرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بموجبه حصلت مستعمراتها كندا، أستراليا، نيوزيلندا، و جنوب إفريقيا على الحكم الذاتي.
و من جهة ثانية، وجب التذكير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، و في إطار توصياتها الرامية إلى تصفية الإستعمار، أصبح حق تقرير المصير للشعوب مرادف لإنهاء الإستعمار و الإنفصال أو الإستقلال عن الدولة المستعمرة، لكن هذا المبدأ يتسم بالخصوصيات، تبعا الطبيعة الإستعمار و الدولة المستعمرة، و لا ينسحب على الدولة التي آلت إليها المستعمرات السابقة، كما هو الحال بالنسبة للأقاليم الصحراوية التي كانت تحت سلطة إسبانيا كدولة مستعمرة، لأن المغرب هو صاحب الحق و ليس المجموعات الإتنية الصحراوية، لأنها تشكل جزء من الشعب المغربي، و لأن الأمر يتعلق بحقوق فردية للأشخاص و ليس بحقوق دولة التي تعود للمغرب، علما أن الحكم الذاتي هو الإطار العام المتبع لحل مسألة الأقليات الاتنية داخل الدولة الموحدة، وبالتالي لا ينطبق عليها الحق في تقرير المصير.
خاصة و أن قبائل الصحراء ارتبطت بالمغرب عن طريق البيعة كالية للتعاقد الديني و السياسي وذلك على مر العصور.
و نظرا لأهمية “الحكم الذاتي”،كشكل من أشكال المشاركة في الحكم، و ليس بوصفه أسلوبا من أساليب الإدارة، سنتولى التطرق إلى خصائص مفهوم الحكم الذاتي في ضوء القانون الدولي والقانون الدستوري، مع إبراز مقومات مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء”، ومدى فعاليتها لإنهاء النزاع في الصحراء المغربية، عن طريق إدماج الساكنة الصحراوية في الدولة المغربية و القطع مع النزوعات الإنفصالية ضمن آلية “الحكم الذاتي”، كحل سياسي قابل للتطبيق.
– (يتبع في الجزء الرابع)